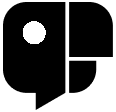صوت المذيعين في الراديو يملأ المطبخ زعيقًا، الاثنان يتنافسان في تمطيط الكلمات وافتعال المرح وارتجال الملاحظات الشخصية، التي يعتقدان أنها ستقرب المستمعين منهما، أداء رديء لا يغري بمتابعة ما يقولانه، الموسيقى العالية حينًا، والخافتة حينًا آخر، تصيب المرء بالصداع، لا أدري لماذا تصر زوجتي على متابعتهما كل صباح.
«أحلى برنامج وأظرف ديو...» ردت وكأنها قرأت أفكاري، وقالت ابنتنا: «والمصروف الذي طلبته... متى سأحصل عليه»؟
التفتت والدتها إليها: «تحدثنا في الأمر، وأخبرتك بأنني سأتصرف».
طلبت أن أفهم ما يحدث... وأجابتني البنت: «أحتاج لبعض المال، بابا، أحتاج إليه اليوم، ولا يمكن أن أنتظر...».
«كفى...» شخطت فيها أمها، وارتفع زعيق الموسيقى الصباحية التي أكرهها.
«هلا أطفأت المذياع الملعون... أو خفضت صوته على الأقل...»؟ سألت زوجتي: «أريد أن أسمع البنت...».
«بابا... طلبوا منا بعض الأغراض في المدرسة، سيشترونها لنا، واليوم هو آخر أجل لدفع ثمنها...».
حملقت في زوجتي بغيظ وأنا أسأل البنت عن المبلغ المطلوب، وأفتح محفظة نقودي...
لم تلق أمها بالاً لما قلته بشأن المذياع، صبت لنفسها المزيد من عصير البرتقال، وأخذت ترشفه وتحذر: «ستفسد البنت... سترى... كنت سأتصل أولاً بالمدرسة لأعرف حكاية هذه الأغراض...».
عاد المذيعان ثقيلا الظل يتباريان في نقل أخبار العالم إلينا: «شبكات الاتجار بالبشر كثرت... وتقارير المنظمات الإنسانية تتحدث عن تضاعف حالات استعباد البشر في أنحاء عديدة من العالم، وبموازاة مع ذلك، ارتفعت وتيرة عمليات اختطاف الأطفال...».
«يا ساتر...» علقت بانفعال «هل هذه أخبار يستمع إليها إنسان عاقل يستعد لبدء يوم عمل شاق... هيا يا ابنتي... لنغادر... ولنترك أمك تستمتع ببرنامجها الأثير...».
رافقتني البنت وهي تكاد تطير من الفرحة، أمها تبالغ في مراقبتها، الصغيرة لم تتمم عامها الثاني عشر بعد، وهي متعقلة ولم يسبق لأحد أن اشتكى منها...
هوس زوجتي ببرامج المذياع كرهه لي، وجعلني أنفر من تشغيله طيلة وقت دوامي، رغم أنني كثيرًا ما أحتاج في لحظات اشتداد الضغط علي، إلى ونيس ينسيني ضوضاء الناس من حولي...
كنت أتناول ساندويتشًا في فسحة الغداء، عندما رن هاتفي وكلمني شخص من مدرسة ابنتي: «عفوا... نريد أن نطمئن على ابنتك، هل هي بخير...»؟
«ماذا تقصد»؟ سألته وأنا لا أفهم: «هل وقع لها مكروه في المدرسة؟ لماذا لم يتصل بي أحد»؟ «لا يا سيدي، نحن لم نرها، لقد تغيبت عن حصص الصباح، ولهذا نتصل...».
«تغيبت؟ ولكنني أوصلتها بنفسي حتى باب المدرسة؟ كيف تتغيب؟ أين ذهبت»؟
كلمت إدارة عملي، وانطلقت نحو أقرب موقف حافلات، رن رقم المدرسة من جديد، وانخلع قلبي وأنا أقفز على الرصيف، وأستقبل المكالمة بتوتر...
في جزء من الثانية، مر شريط فطورنا الصباحي أمام عيني...
البنت وهي تصر على أخذ مبلغ محترم من المال، أمها وهي تمانع وتقول إنها تريد الاتصال بالمدرسة أولاً للتأكد من الأمر، أنا أخرج محفظة نقودي بغباء، البنت تنط من حولي بفرح مريب، أخبار الاتجار بالبشر في المذياع، حالات اختطاف الأطفال... يا إلهي... أتكون زوجتي على حق؟ هل رميت ابنتي بين أنياب المجرمين؟ أين هي الآن؟ هل صرفت المال في مكان ما في المدينة؟ هل ذهبت إلى ساحة الملاهي، أو إلى السيرك، أو إلى السينما...؟ هل هي برفقة أحدهم؟ هل هي بخير...؟
«آلو...»، رددت بصوت مرتجف، وقد عرقت يداي من التوتر، ورد نفس الشخص الذي كلمني أول مرة، بنبرة هادئة، فيها شيء من المرح:
«نأسف للإزعاج سيدي، هناك سوء فهم، أخطأ أستاذ العلوم ووضع علامة أمام اسم ابنتك في لائحة الغياب، ابنتك بخير، وهي لم تتغيب، معذرة سيدي...».
فغرت فمي من الذهول، ولأول مرة في حياتي... لأول مرة حقًا... فوتت حافلتي..
نعم فوتتها.
مرت أمامي في المنحدر الزلق الذي توقفت أعلاه، وغادرتها لأرد على مكالمة المدرسة... ونسيت من فرط هلعي... أنا سائق الحافلات المخضرم الذي أمضى أكثر من خمس وعشرين سنة في سياقة مختلف أنواع العربات، أن أضغط على الفرامل....